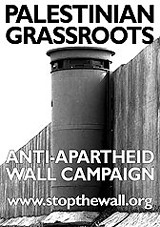أصلي المغرب ثم أشرع في إرتداء ملابسي، أفتح الدولاب وتبحث عيني عن اللون الأسود، فلا أجد. أبحث بجدية أكثر، لكن لا يسفر هذا البحث سوى عن جاكيت رمادي؛ يكون هو أقرب ما أجد للأسود. أخشى ألا يكون مناسباً فأتجه لدولاب أمي، أجد "بلوفر" أسود ولكنني أدرك أنه سيكون واسعاً جداً علي، فأرضى بالجاكيت الرمادي. أرتدي ملابسي في صمت ثم أقف أمام المرآة لأرتدي الإيشارب (الرمادي أيضاً). أحملق في وجهي الخالي من المساحيق بالمرآة، وأتذكر عندما كنا صغاراً -حتى فترة قريبة- كان عندما يتحتم علينا الذهاب مع أمي إلى عزاء، ترفض رفضاً باتاً إرتداءنا أنا وأختي للأسود. "إنتو لسه صغيرين على الأسود"، كانت تخبرنا، فنكتفي بالبني أو البيج أو أياً من غوامق الألوان. ابتسم لنفسي في المرآة محادثة إياها: "إنتي كبرتي يا نوران. ولازم يبقى عندك حاجة سودة في دولابك". أنهي ارتداء ملابسي ثم أتساءل إن كان ارتداء عقدي الفضة مناسباً أم لا: أوقظ أمي لأسألها: "هو كده
too much?!"
فترد بلا. أذهب إلى غرفتي ثم أعود لأسألها: "طب هو فيها حاجة لو حطيت بارفانة؟"، فتخبرني أنني "مش من أهل المتوفي -لا سمح الله- فمفيهاش حاجة يعني". ترعبني فكرة جرح أهل المتوفي بأي شكل من الأشكال، فأحرص كل الحرص أن تتأكد أمي من شكلي العام قبل أن أهم بالخروج. ا
ا
أخطو إلى الشارع أمام العمارة، ولسبب ما أنظر إلى السماء، فأفاجأ بسرب من العصافير البيضاء طائراً من يساري إلى يميني، وكأنه ظهر في نفس اللحظة التي لامست فيها قدمي أرض الشارع. أحملق للحظة في السماء، ثم للحظة في الأسفلت، ثم السماء مرة أخرى حتى أتأكد أنها ليست هلاوس، ولكن العصافير هناك. تطير بدون صوت، ولكنها بالتأكيد موجودة. أبتسم في تعجب قائلة لنفسي "عصافير إيه دي اللي بتطير بالليل؟!" أصل إلى مكان العزاء، وتبحث عيني تلقائياً عن دكتور سهير ومنى، أجدهما، فأتجه إلى دكتور سهير وأحتضنها طويلاً. أسلم على الموجودين ثم أجلس في المكان الخالي إلى جوار منى. أثبت عيني على الوجه الملائكي الذي يبكي تارة ويتمتم تارة، وأتمنى لو كان المكان بجوارها خالياً حتى أجلس بجانبها و"أطبطب" عليها. تلتقط أذناي من السماعات "وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون" فتتسارع الدموع إلى عيني دون سبب وأهمهم "بالحمد لله". ا
ا
أتشاغل بالنظر إلى الأطفال الموجودين مع أمهاتهم، فأجد أنهن ثلاث بنات، يرتدين بالصدفة جميعاً اللون الوردي، فأفكر في أنهن يبدون مثل الفراشات -تماماً مثل الفراشات. أتذكر أن فرح سلمى لم يمض عليه أسبوع، وأن ترقية دكتور سهير -التي تأخرت أعواماً- لم تكمل ثلاثة أيام، فأتعجب في صمت. ا
ا
تهم منى بالقيام فأدعوها لأن نستمع لربع آخر نقوم بعده. يبدأ المقرئ بسورة "مريم"، فأنظر لمنى ونبتسم سوياً، فقد كنا نتحدث عن تلك السورة بالأمس فقط. كنت أسري عن نفسي خلال محاضرة الأمس البشعة بكتابة الآيات الخاصة بقصة "ستنا مريم" -كما أحب أن أسميها- في دفتري. أتلو الآيات في سري مصاحبة لصوت المقرئ. أفكر في هذه الفتاة الصغيرة -تقول الروايات بأن عمرها لم يتعد الثلاث عشرة سنة عند حملها بالمسيح- في خوفها عندما يظهر لها سيدنا جبريل، فتحتمي بربها: "إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً". أفكر في قلقها ورعبها مما سيظنه قومها. أفكر في أنها كانت وحدها؛ طفلة وحيدة تتحمل كل ذلك. هل وسط كل الآلام النفسية والجسدية التي كانت تكابدها أثناء الولادة، كانت تعلم أنها تلد الحب والرحمة والآية؟ يوجعني قلبي دائماً عندما تأتي آية "فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً"، فأتمنى لو كنت معها لأمسك بيدها الصغيرة وأطمئنها بأن كل شيء سيكون على ما يرام. ا
ا
ينتهي الربع فننهض أنا ومنى. أحتضن دكتور سهير مرتين موصية إياها: ا
"Please be fine ya Doctor"
فترد بابتسامة منهكة: "ربنا يخليكوا ليا". أخرج أنا ومنى من القاعة فتلفحنا نسمة باردة، أحتمي منها بانكماشي على كتف منى. أخبرها عن "العصافير المجنونة اللي مش بتظهر غير للمجانين اللي زيّنا" فنضحك سوياً. نتمشى قليلاً قبل أن نفترق كل إلى وجهتها. أركب التاكسي وأنظر عبر الزجاج المغبش إلى المصابيح المضيئة في وسط ظلام الشارع، تبدو وحيدة و"بردانة"، ويبدو ضوئها خافتاً، ولكنها تلقيه بالرغم من كل شيء. ا